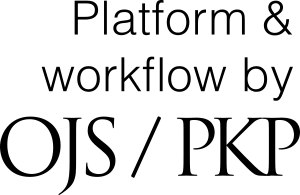المحفوظات
-
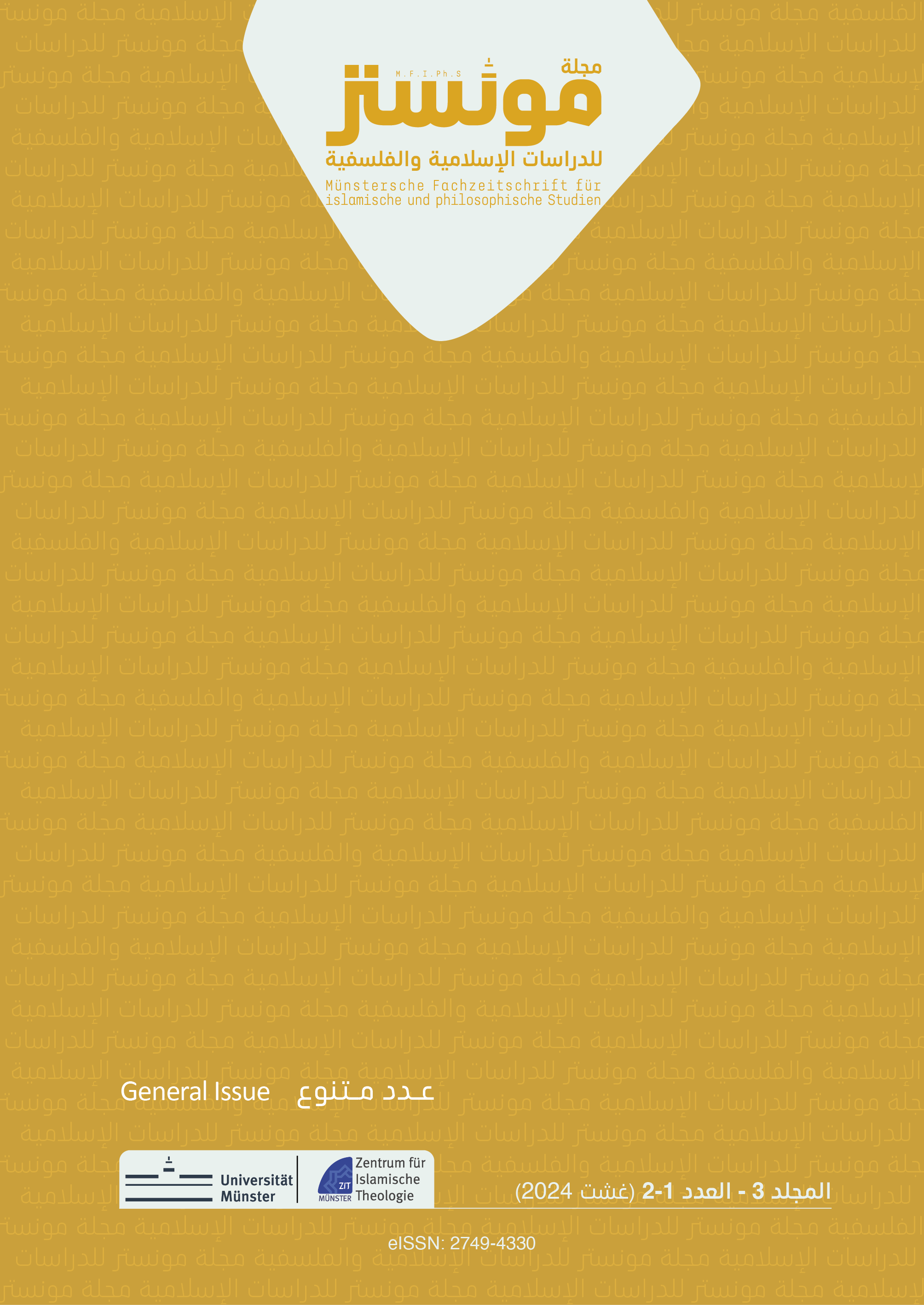
عدد متنوع
مجلد 3 عدد 1-2 (2024)يسرنا أن نقدّم للقراء الكرام هذا العدد المتنوع من دورية "مونستر للدراسات الإسلامية والفلسفية"، الذي يضم مجموعة من المقالات البحثية التي تتناول موضوعات متنوعة ومهمة في مجال الفلسفة الإسلامية والدراسات الفلسفية. يعكس هذا العدد التزامنا بتقديم أبحاث رصينة تعزز الفهم العميق للقضايا الفلسفية والدينية، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة في هذا المجال.
يبدأ هذا العدد بمقالة نجيب جورج عوض، حيث يستعرض فيها تطور الفلسفة في العالم العربي الإسلامي المعاصر، من خلال قراءة تحليلية لفكرة "الفلسفة الإسلامية" في ضوء مفهوم الفلسفة كما تبلور في العصر الإسلامي المبكر. يعود الباحث إلى اللحظات الأولى التي طوَّر فيها العرب المسلمون في العصر العباسي المبكر خطابًا فلسفيًا يعبر عن فهمهم لطبيعة ودور الفلسفة، مستندين إلى الإرث الفلسفي اليوناني بشقيه الأفلاطوني والأرسطي. تركز المقالة على نصوص يعقوب ابن اسحق الكندي وأبي نصر محمد الفارابي، ويستخلص الباحث نتائج حول مدى اهتمام هؤلاء الفلاسفة بأسلمة الفلسفة.
في مقالة رمضان بن رمضان، يتم تناول الجدل حول مفهوم "الصرفة" وعلاقته بالإعجاز القرآني. يدرس الباحث تحولات هذا المفهوم داخل التيار الاعتزالي من القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس الهجري، وكيف تم تكييفه ليكون منسجمًا مع التوجه العام في مباحث الإعجاز القرآني. تُناقش المقالة الأبعاد الثيولوجية واللغوية لهذا المفهوم وأثره على الفهم القرآني.
وفي المقالة الثالثة، يقدم محمد أسامة بن عطاء الله في مقالته دراسة عن إسهامات رفائيلي بيتازوني في علم الأديان، مركزًا على دوره في تجاوز التوتر المنهجي بين الفينومينولوجيا والتاريخ. يستعرض الباحث كيف أن بيتازوني شكّك في شرعية النتائج التي أفرزتها النظريات الكلاسيكية حول أصل الدين، ودعا إلى تبني مقاربة فينومينولوجية تتيح فهمًا أعمق للظواهر الدينية وتكاملها مع المنهج التاريخي.
في حين تسلط ريتا فرج في دراستها الضوء على أعمال إليزابيث شوسلر فيورنزا ومنهجها في لاهوت التحرير النقدي النسوي. تشرح الدراسة كيف أن فيورنزا أسست منهجها على أربع ركائز: هرمينوطيقا الشك، هرمينوطيقا التذكر، هرمينوطيقا الخيال، وهرمينوطيقا الإعلان. كما تستعرض أبرز خلاصات فيورنزا حول "حركة يسوع" و"كنيسة النساء".
في مقالة النقد التاريخي لِيان هووارد مارْشال المُترجم من طرف بشرى النواسي، يتم تقديم نظرة شاملة على النقد التاريخي للعهد الجديد. يوضح مارشال كيفية تطبيق العلوم التاريخية لفهم النصوص الدينية القديمة، والتحديات التي تواجه المؤرخين في هذا المجال، وأهمية النظر في أهداف كاتبي النصوص الدينية.
تختتم مقالات العدد بترجمة محمد أسامة بن عطاء الله لنص رفائيلي بيتازوني حول العلاقة بين التاريخ والفينومينولوجيا في علم الأديان. يقدم بيتازوني في هذه المقالة دعوة لتبني مقاربة فينومينولوجية تعزز فهم الظواهر الدينية في سياقها التاريخي، مع الحفاظ على البعد الترانسندنتالي للدين.
وفي قسم القراءات قدم محمد الريوش قراءته لكتاب الفقه الحنفي بإفريقية في القرن 3هـ/ 9م، لنجم الدين الهنتاتي.
نأمل أن تسهم هذه المقالات في إثراء النقاش الأكاديمي وتعزيز الفهم المتبادل بين الباحثين والقراء في مجالات الفلسفة والدراسات الإسلامية. -
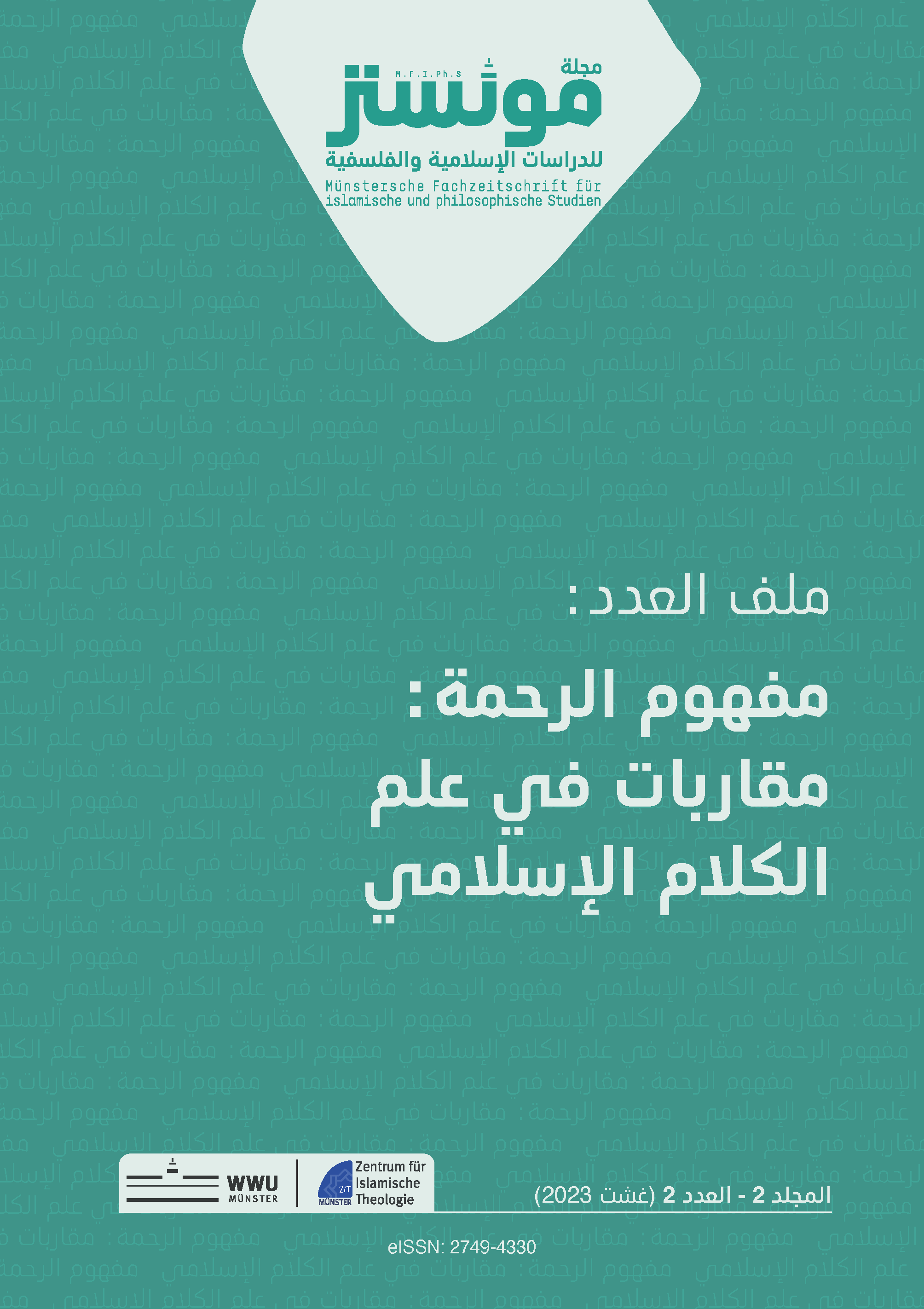
مفهوم الرحمة: مقاربات في علم الكلام الإسلامي
مجلد 2 عدد 2 (2023)لاسم الله «الرحمن» جُذورٌ في نصوص اللُّغات الساميّة، تُفيد في إحدى معانيها «الإله المُحبّ»، وقد جاء القرآن ليُعيد هذه الدّلالة الكامنة في التوراة والإنجيل وبالتناص معهما، حيث يُفرِّق بين اسم الله الرّحيم، بمعنى الرحمة التي تغفر الذنوب؛ وبين الرحمن بمعنى الرحمة الـمُحبّة للإنسان، وهي مقام يفوق مُجرَّد الشّفقة أو المغفرة. كما يتقاطع القُرآن بشكل أوثق مع الإنجيل من خلال تركيزه على هذا المعنى الكامن باعتباره أساس العلاقة بين الله والإنسان، حيث الرّحمة الإلهيّة مُتّجهةً لمحبَّة الإنسانيّة، ومن ثم تسمح بالتأسيس للاهوت الرحمة، كما هو الحال في لاهوت المحبة في نصوص العهد الجديد.
هل بإمكاننا اليوم أنْ نتحدَّث عن الرّحمة الإلهيّة باعتبارها أساس علاقة الله بالإنسان؟ وداخل أيِّ أُفقٍ يُمكننا ذلك؟نسعى من خلال هذا العدد إلى عرض مفهوم الرحمة للنقاش الكلامي الإسلامي من جديد، ليس من مُنطلق البحث عن تأسيس اعتزالي أو أشعري أو ماتريدي لمفهوم الرحمة، وإنما البحث في تاريخ الأفكار عن دواعي غياب الرحمة في البنية الذهنية للكلام الإسلامي، والبحث عن إمكانات أخرى لِتأسيس المقولات اللاهوتية بما في ذلك «لاهوت الرحمة» على «حدود مُجرّد العقل».
تأمل مجلة مونستر للدراسات الإسلامية والفلسفية أنْ يكون هذا العدد فُرصةً لفتح نقاش بين الباحثين المُهتمين لتعميق الدراسة في موضوع الرحمة من منظورات لاهوتية وفلسفية مُختلفة.
-
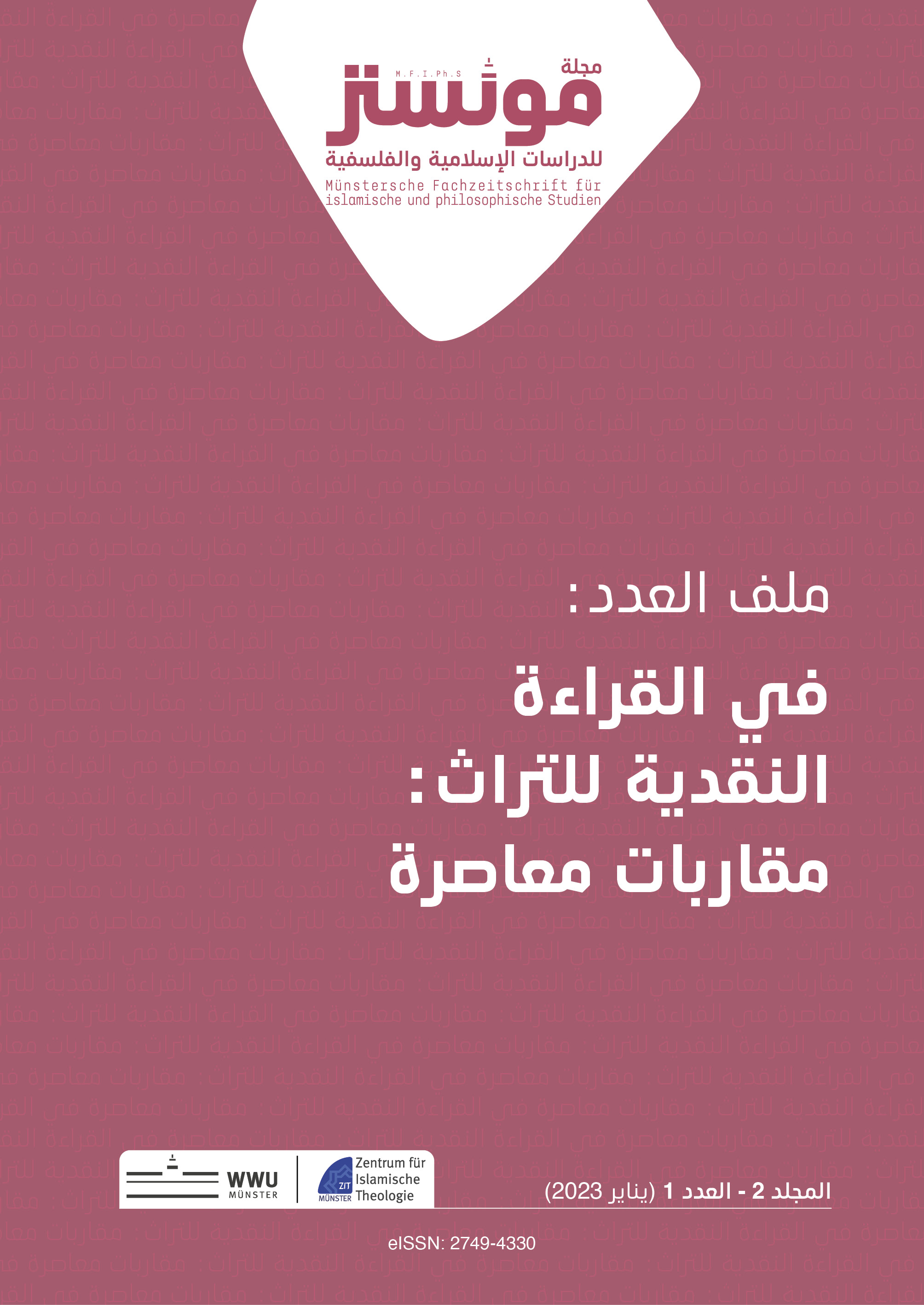
في القراءة النقدية للتراث: مقاربات معاصرة
مجلد 2 عدد 1 (2023)لقد أثَّرتْ الأحداث السياسيّة المُتلاحقة في منطقة «مينا» (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) على سمعة الإسلام تأثيرًا بالغًا، وأضحتْ أسئلةٌ من قبيل: هل في الإسلام تنوير؟ وهل يمكن إصلاح الإسلام أو تجديده؟ شائعة في الساحات الثقافية العمومية والأكاديمية على السواء. تنوعتْ الإجابات وتعدَّدتْ، لكنَّها في الغالب تأخُذ منحيين رئيسيين: منحى يثبت أصالة التنوير في الإسلام، وأنه -أي التنوير- صفة ذاتية له، ثم يفترقون في تعيين مجال الفكر التنويري في التجربة الإسلامية؛ فمنهم من استدعى مواطن العقلانية في التاريخ، وغالبا ما يكون ابن رشد (الجابري 2007) وابن خلدون (العروي، 1996) المثالين الأبرزين؛ ومنهم من عمد إلى البحث في التجربة الصوفية الإسلامية واستحضار نماذج من قبيل ابن عربي الأندلسي (المصباحي 2006)؛ ثم هناك اتجاه ثالث عاد إلى تراث الأخلاقيين الإسلاميين كمسكويه وأبي حيان التوحيدي وغيرهما لإثبات بذرة إنسية في التراث العربي (أركون 1997)؛ ومنهم من عاد إلى التراث الاعتزالي بصفته تراثًا تنويريًّا (حنفي 1988)، ودعا إلى تثويره في الواقع الحديث لإنتاج حداثة عربية لا تعاني من الأعطاب الحداثية التي عرفتها التجربة الأوروبية.
أما المنحى الثاني فينفي علاقة الإسلام بالتنوير، من جهة أن التنوير مقولة تاريخية، كانت لها شروط وسياقات خاصة، في حين أنَّ الإسلام في تجربته التاريخية كان مُعتمدًا على مقولات جوهرانية أنتجها الفقهاء والمُتكلِّمون، نأتْ به عن أية إمكانات تنويرية؛ فلا «الذات الديكارتية» هي الذات التي تحدث عنها المُتكلِّمون (المصباحي 2017)، ولا «العقل الكانطي» هو ما قصده المُعتزلة والفلاسفة عند حديثهم عن العقل (العروي 1996). فهل هذا التراث، لاسيما الفقهي منه الذي ارتبط بالسلطة، والعقدي الذي حد من قدرة الإنسان هو السبب في تأجيل سؤال التنوير؟ ومن ثم، عدم استيعاب الإسلام لمقولتي التجديد والإصلاح؟
إنَّ ما يُمكن مُلاحظته من الوهلة الأولى، هو ارتباط مفهوم التنوير بمفهومي الإصلاح والتجديد، ثم ارتباط كل هذه المفاهيم بالعقل، أو بالقراءة النقدية للتراث إذا رمنا أن نكون أكثر تحديدًا. من هذا المُنطلق ارتأينا أن نستأنف القضية التي عرضناها في ملف المجلد الأول (2022)، بملف العدد الأول من المجلد الثاني (2023) المعنون بـ: «في القراءة النقدية للتراث: مقاربات معاصرة»، الذي سيتطرق لعدد من المشاريع المُعاصرة التي شكَّلتْ، وماتزال تُشكل، القاعدة التي تنطلق منها النقاشات حول علاقة الإسلام بالتنوير والإصلاح والتجديد.
إنَّ عرض هذه المشاريع هو فرصة لفتح نِقاش علميّ أكاديميّ بشأنها وحول القضايا التي تطرحها، للنظر في حدودها والإمكانات الكامنة فيها؛ والأهم من ذلك؛ وهو الغرض من إنشاء مجلة مونستر للدراسات الإسلامية والفلسفية: «إعادة التفكير في الدين الإسلاميّ من خلال معرفة ما نحن عليه اليوم وما يُمكن أن نكون عليه غدًا».